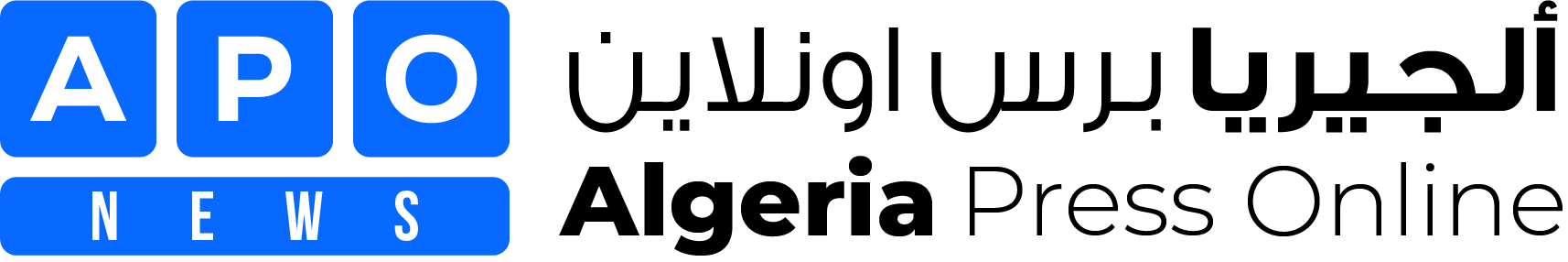الرباعي أويحيى وآدمي وزروال وبتشين وراء” الأيادي النظيفة”
“إطاراتنا يجرّمون ويزج بهم في السجن دون وجه حق”
زروال “متهم”و توفيق”مدان” وبوتفليقة “بريء”
تاريخيا، وزير العدل الأسبق، محمد آدمي، هو من حرك الدعوى العمومية بواسطة النيابة التي تتبع له، ضد المسيرين العموميين. وسياسيا، أحمد أويحيى كرئيس للحكومة آنذاك هو من أعطى للقضية لباسا سياسيا فسميت “حملة الأيادي النظيفة”. لكن لم يكن للرجلين أن يتحركا لمتابعة العشرات من الكوادر، من دون ضوء أخضر من الرئيس اليمين زروال وكبير المستشارين بالرئاسة، الجنرال محمد بتشين.
أما الظروف العامة التي جاءت فيها حملة ملاحقة إطارات الشركات العمومية، فتميزت بخضوع الجزائر لبرنامج التصحيح الهيكلي المفروض من صندوق النقد الدولي، الذي منح الجزائر قرضا مقابل أن تسلمه اقتصادها ليديره. ونجم عن ذلك غلق العشرات من المؤسسات العمومية وتسريح الآلاف من العمال، وإطلاق برنامج لخوصصة الشركات المفلسة، الذي صرفت فيه الدولة مئات الملايير في إطار ما سمي بـ”تطهير المؤسسات”، من دون أن تجد من يشتريها في النهاية وتخلت عنه الحكومة، ولا أحد دفع حساب هذا الخيار الكارثي.
وقد أفرز انخفاض برميل النفط في تلك الفترة (1995 – 1998)، وضعا اقتصاديا خطيرا. وبلغت الأزمة حد العجز عن شراء باخرة قمح من الخارج لصناعة خبز المواطنين. ومن تابع الأحداث في تلك الفترة الصعبة، يتذكر تصريح رئيس الحكومة مقداد سيفي (عام 1994)، بأن الشعب الجزائري لا يملك رغيف يومه، وأعلنت الحكومة في تلك الظروف عن رفع سعر الخبز إلى 7,50 دنانير لكنه يباع بـ10 دنانير.
وما زاد الأزمة تعقيدا، الإرهاب الذي كان قد حصد في 1995 الآلاف من الأرواح ودمر البنية التحتية، بحرق وتخريب المرافق العمومية والشركات. زيادة على الضغط الخارجي الذي واجهته السلطة آنذاك، من طرف عواصم غربية وبخاصة فرنسا التي رفضت دعم الحكومة في حربها مع الإسلاميين المسلحين، بحجة أن الوضع في الجزائر غامض. ومن هنا نشأ الجدل حول “من يقتل من؟”، بمعنى أن الاغتيالات والمجازر الجماعية والتفجيرات لم يكن يعرف من يقف وراءها.
في هذا الجو المعقد المليء بالشكوك والمطبوع بمستقبل ضبابي وأفق مسدود، عاش نظام الجزائر أحلك أيامه منذ الاستقلال. وأمام عجزه عن مواجهة الأهوال في الداخل والخارج، سعى إلى البحث عن متنفس في محاولة للتأكيد على أنه يتحكم في الوضع، فلجأ إلى تحميل مسيري القطاع الاقتصادي العمومي مسؤولية التجارب الخاطئة التي أفرزت تفكيكا منظما للشركات الحكومية الكبيرة. واختار النظام من قانون العقوبات، المواد التي تجرم سوء التسيير والاختلاس وتبديد المال وطبقها على العشرات من مديري الشركات.
ويذكر عبد الله هبول، الذي كان قاضيا في تلك الفترة، لـ”الخبر”، عن حملة الأيادي النظيفة وسياقها: “على عكس ما يقول عمار سعداني، فالتحقيقات التي كانت مبررا لملاحقة مسيري القطاع العام آنذاك، لم يقدها جهاز الاستخبارات العسكري الذي كان غارقا في محاربة الإرهاب، بل أنجزتها مصالح الشرطة والدرك. وأويحيى وآدمي هما من وفرا الغطاء لمتابعة حوالي 200 مسير، ولكن لم تكن لهما القوة السياسية التي تسمح بذلك، برأيي، لولا تزكية من الرئيس زروال والوزير المستشار بتشين. هذا التفصيل التاريخي مهم للغاية، لوضع ما سمي بحملة الأيادي النظيفة في سياقها الصحيح”.
وأضاف القاضي أن أشهر القضايا حينذاك هي شركة جيني سيدار بعنابة، مشيرا إلى أن “الملفات التي تشكلت بناء على دعاوى كانت تأخذ وقتا طويلا، إذ قضى المتهمون سنين في الحبس الاحتياطي بدون محاكمة، ما أثار سخط عائلاتهم، ووجد ذلك صدى في الإعلام. وبعد مدة الحبس الطويلة، غادر المسيرون المتهمون السجن، مستفيدين من البراءة، من دون أن يقفوا أمام القاضي. وهذا هو الفرق بين هذه القضايا، وقضيتي سوناطرك والطريق السيار الحديثتين اللتين صدرت فيهما أحكام. وعندما يصرح سعداني أن المدانين في هذين الملفين مظلومون، فهو لا يعترف بأحكام القضاء بحقهم، مع العلم أن الأحكام محل طعن بالنقض، بمعنى أن القضاء لم يقل كلمته النهائية في القضيتين، فكيف لسعداني أن يحكم بأنهم ظلموا ؟!”.